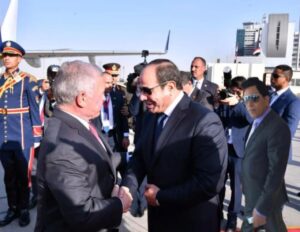ليست المؤامرة دائمًا صاخبة، ولا تُعلن عن نفسها ببيانات رسمية أو جيوش جرّارة، بل كثيرًا ما تولد في صمت الغرف المغلقة، حيث تُدار خرائط العالم على طاولات باردة، وتُختزل مصائر الشعوب في أرقام ومؤشرات. ومن هنا يبدأ الحديث عن المنظمات السرية ودولة العالم الواحد، ليس بوصفها خيالًا سياسيًا، بل كمنظومة مصالح حقيقية تعمل في الظل، وتتقاطع عند هدف واحد: إعادة تشكيل العالم بما يخدم قلة تتحكم في المال والإعلام والقرار.
المنظمات السرية، في معناها الأوسع، ليست جمعيات تحمل أسماء غامضة فحسب، بل شبكات نفوذ متشابكة تضم رجال مال، ومراكز أبحاث، وشركات متعددة الجنسيات، ولوبيات ضغط، وأذرع إعلامية وثقافية. هذه الشبكات لا تحكم العالم بشكل مباشر، لكنها تؤثر في صناع القرار، وتوجّه السياسات، وتحدد أولويات الدول، حتى باتت الحكومات في كثير من الأحيان منفذة لا صانعة، ورد فعل لا فعلًا مستقلًا. ومن خلف الستار، تُصاغ الاستراتيجيات بعيدة المدى، لا وفق احتياجات الشعوب، بل وفق مصالح النخبة المسيطرة.
أما فكرة “دولة العالم الواحد” فهي الغطاء الأيديولوجي لهذه الشبكات. تُقدَّم للعالم على أنها حلم إنساني نبيل: عالم بلا حدود، بلا حروب، بلا صراعات. لكن خلف هذا الخطاب اللامع تختبئ حقيقة مختلفة؛ عالم بلا سيادة حقيقية، بلا هوية راسخة، وبلا قرار وطني مستقل. دولة لا يُحكم فيها البشر بالقيم، بل تُدار فيها الشعوب بقوانين السوق، حيث يصبح رأس المال هو الجنسية الوحيدة المعترف بها، وتُقاس قيمة الإنسان بقدرته على الاستهلاك لا بإنسانيته.
في قلب هذا المشروع، تبرز الصهيونية العالمية كفكر ممتد، لا يقتصر على دعم كيان سياسي بعينه، بل يقوم على ضمان التفوق الدائم، وإدامة حالة الفوضى المحسوبة في مناطق بعينها، وعلى رأسها العالم العربي والإسلامي. فالدولة القوية المستقرة تمثل خطرًا على مشاريع الهيمنة، أما الدولة المنهكة بالصراعات والانقسامات فهي أرض خصبة للتدخل والتوجيه والابتزاز السياسي والاقتصادي. ومن هنا كان استهداف الشرق الأوسط تحديدًا، لأنه القلب الجغرافي للعالم، ومخزن الطاقة، ومفترق الطرق، وموطن الرسالات.
ما يُخطط له في الغرف المغلقة يبدأ غالبًا بإضعاف الداخل قبل مواجهة الخارج. ضرب الثقة بين الحاكم والمحكوم، تشويه الرموز الوطنية، إعادة كتابة التاريخ، وتفريغ القيم من مضمونها. ثم تأتي مرحلة الفوضى الناعمة، حيث تُدار الصراعات بالأفكار والشائعات والإعلام الموجَّه، قبل أن تتحول – عند الحاجة – إلى فوضى خشنة بالسلاح والدمار. وفي كلتا الحالتين، المستفيد واحد، والضحية واحدة: الشعوب التي تُستنزف دون أن تعرف من يحرك الخيوط.
الإعلام هنا ليس ناقلًا للحدث، بل صانعًا له. تُضخ الروايات المعلبة، ويُعاد تعريف المفاهيم، فيصبح المقاوم إرهابيًا، والمحتل ضحية، والعدالة مطلبًا متطرفًا. وتحت عناوين حقوق الإنسان والديمقراطية، تُبرر التدخلات، وتُفرض العقوبات، وتُحاصر الدول التي تحاول الخروج عن النص المرسوم لها مسبقًا. أما من يرفض، فيُعزل، ويُشوَّه، وتُفتح عليه كل أبواب الضغط.
والاقتصاد هو القيد الأشد إحكامًا. ديون، واتفاقيات، وشروط قاسية، وأسواق مفتوحة بلا حماية، تُفرغ الدولة من قدرتها على الإنتاج، وتجعلها رهينة للممولين. وحين تعجز عن السداد، يُفتح الباب للتنازل عن القرار، وعن الموارد، وأحيانًا عن الأرض، تحت مسميات براقة مثل “الإصلاح” و“الإنقاذ” و“الاندماج في الاقتصاد العالمي”.
ودولة العالم الواحد، في حقيقتها، لا تريد إنسانًا حرًا واعيًا، بل فردًا منزوع الجذور، مقطوع الصلة بتاريخه ودينه وثقافته، يسهل توجيهه واستهلاكه. لذلك تُستهدف الأسرة، وتُشوَّه القيم، ويُسخر من الثوابت، حتى يصبح الدفاع عنها تهمة، والتمسك بها رجعية في نظر الأجيال الجديدة.
وفي نهاية هذا المشهد المعقد، تتضح الصورة كاملة لمن أراد أن يرى دون أقنعة. فما يجري في العالم العربي والإسلامي والشرق الأوسط ليس أحداثًا متفرقة ولا أزمات عشوائية، بل حلقات متصلة في سلسلة طويلة من التخطيط المحكم، ظاهرها صراعات داخلية وباطنها صراع على الهوية والموقع والثروة والقرار. فكل حرب تُشعل، وكل فتنة تُغذّى، وكل دولة تُنهك، ليست إلا خطوة محسوبة في طريق إعادة تشكيل المنطقة بما يخدم مشروع الهيمنة الكبرى ودولة العالم الواحد.
في الظاهر تُرفع شعارات الإصلاح، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، ومحاربة الإرهاب، بينما في الخفاء تُدار الصفقات، وتُقسم مناطق النفوذ، وتُرسم خطوط التفكيك. يُراد للمنطقة أن تبقى ساحة مشتعلة بلا نهاية، حتى لا تقوم لها قائمة، ولا تتفرغ للبناء أو للنهضة أو لاستعادة دورها التاريخي. يُراد لها أن تُستنزف في صراعات مذهبية وعرقية وحدودية، بينما العدو الحقيقي يراقب من بعيد، ويدير اللعبة دون أن يدفع الثمن.
المخطط أخطر من مجرد إسقاط أنظمة أو تغيير خرائط، فهو يستهدف الإنسان ذاته؛ عقله أولًا، ثم روحه، ثم انتماءه. يُراد للعربي والمسلم أن يفقد ثقته في تاريخه، وأن يشك في دينه، وأن يخجل من هويته، حتى يصبح تابعًا بلا مقاومة، ومستهلكًا بلا إرادة. وحين تُفرغ الأمة من وعيها، يصبح كسرها مسألة وقت لا أكثر.
وفي الغرف المغلقة، حيث لا تُرفع الأعلام ولا تُتلى البيانات، تُناقش سيناريوهات التفتيت الناعم والخشن: دول تُجزأ، وجيوش تُستنزف، واقتصادات تُربط بسلاسل الديون، وإعلام يُعاد تشكيله ليخدم رواية واحدة. أما فلسطين، فتبقى جوهر الصراع وبوصلته، لأنها الشاهد الأكبر على طبيعة المشروع الصهيوني، ولأن بقاءها حية في الوعي يعني سقوط كل الأقنعة الأخرى.
لكن ورغم هذا الظلام المتكاثف، تبقى الحقيقة الثابتة أن ما بُني على الظلم لا يمكن أن يستقر، وأن الأمة التي مرت عليها قرون من الاستهداف والتآمر ولم تنكسر، لن تُمحى بإرادة غرف مغلقة مهما بلغت قوتها. فكل محاولة لطمس الهوية تولد مقاومة، وكل مشروع لتزييف الوعي يوقظ عقولًا جديدة، وكل ضغط يولد انفجارًا معاكسًا.
إن المعركة اليوم ليست معركة سلاح فقط، بل معركة وعي وبصيرة وصمود. معركة فهم ما هو ظاهر وما هو مخفي، وما يُقال وما يُضمر، وما يُخطط في العلن وما يُدار في الظل. وحين يدرك الإنسان العربي والمسلم أن استهدافه ليس بسبب تخلفه بل بسبب موقعه وثرواته وتاريخه، تتغير قواعد اللعبة، ويبدأ طريق استعادة الذات.
وفي النهاية، قد تنجح المخططات في إيلام المنطقة، وقد تطيل أمد الجراح، لكنها لن تنجح في قتل الروح. فالأوطان لا تموت، والعقيدة لا تُمحى، والهوية لا تُفكك إلا إذا تخلى عنها أصحابها. أما إذا بقي الوعي حيًا، فإن كل دولة عالم واحد تُراد لنا، ستسقط أمام حقيقة واحدة: أن هذا الشرق، رغم كل ما يُحاك له، لم يكن يومًا أرضًا سهلة الانكسار، وسيبقى عصيًا على الذوبان مهما اشتدت العواصف.